
ممتع الجلوس مع محمود درويش والتحادث معه، ليس لأنّه شاعر فلسطين واسمها الآخر، ولا لحضوره الرمزي الكبير عربياً، ولكن ـويجدر قول ذلك أحياناً- لأنّه شخص ممتع. التقيته في غرفته في الفندق خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت حيث أقام أمسية وكُرّم في جامعة البلمند، وكانت المرة الثانية التي ألتقيه فيها هناك. استقبلني بالطريقة نفسها، بالكرم الشخصي نفسه، الذي يسقط هيبة اللقاء ويدخل محلها نوعاً من الخفة اللطيفة، من "أهلاً وسهلاً" التي يقولها غامرة عالية إلى طريقة المصافحة يقول لك محمود درويش إنّك بتّ صديقاً، وبالأحرى يحثك على إنشاء علاقتك معه على هذا النحو، بعد ذلك يشرع في حديث يريده عادياً، يسألك عن نفسك وعن بيروت وعن بعض الأصدقاء، ويحدثك عن نفسه، وعن بيروت وعن بعض الأصدقاء، يجلس على الكنبة نفسها التي جلس عليها المرة السابقة، وكأنّه اعتاد طويلاً الجلوس عليها، وكأنّه يجعلها كنبته، مفتاحه إلى غرفة غريبة في فندق غريب، وهذه أظنها من عادات درويش التي تعلمها خلال أسفاره وترحالاته الكثيرة؛ أي كيف يألف الأمكنة الغريبة ويروضها؛ إذ على الرغم من عمومية درويش؛ أي كونه شخصاً عامّاً بامتياز، وربما بسبب ذلك، فإنّه يحرص على إظهار هذه الناحية الشخصية؛ فالرجل هو أيضاً رجل عزلة، وهذا ربما أحد أسراره؛ أي أن يكون قادراً على حمل نفسه ونفسه وحدها، ليشكّل منها أينما وجد، ومهما كانت فترة إقامته قصيرة وعابرة، ما يشبه شرنقته الخاصة، عالمه الخاص، فرديته.
كان أبي رجلاً خجولاً جداً، يعاملنا بمسافة، وكان أيضاً رجلاً حزيناً، لأنّ هموم الحياة انقضّت عليه باكراً جداً حين انتقل من مالك أرض إلى عامل في أرض، وحمل أعباء عائلة كبيرة
في مقابلتي الأولى معه تحدثت ودرويش في السياسة، في الراهن الفلسطيني الفارض حضوره عليه وعلينا، والأرجح أنّ درويش خلال زياراته الكثيرة تحدث كثيراً في السياسة حتى تعب. يسألني إذا ما شاهدت حواراً تلفزيونياً كان أجراه قبل يومين، كان فيه الكثير من السياسة أليس كذلك؟ يسألني لكن كان فيه الشعر أيضاً، أجيبه وكأنّني أطمئنه إلى أنّ السياسة لم تحتكر كل شيء مثلما تهدد دائماً أن تفعل.
يأتي المصور، تبدو على وجه درويش علائم اللاارتياح، يحب درويش صوره ويسألك باهتمام عنها، لكنّه لا يجد نفسه ملائماً للتصوير، "أتعرف أنّني ولا مرة شعرت أنّ وجهي تحبه الكاميرا... أشعر أنّني تحت وطأة سلوك رسمي له متطلبات التخاطب بالفصحى مثلاً"، أخرج آلة التسجيل فتكمل معه: "هل ضرورية هذه؟ ألا نستطيع التحدث من دونها"؟ بلى، نستطيع أن ننسى وجودها، أجيبه، "حسناً، سنتحدث إذاً بالعامية".
طوال (3) ساعات تحدثت ودرويش حتى نسينا -أنا وهو- أنّنا نجري حديثاً صحفياً، غابت الشمس وحلّت العتمة في الخارج، ومع هذا التبدل في الطقس تبدلت نبرة درويش، خفتت، ودخل على وجهه شيء من العتمة الآتية من الخارج، قبل أن ينتبه إلى إضاءة المصباح الكهربائي الآخر في الغرفة.
محمود درويش قامة شعرية وإنسانية كبيرة، تخرج من الحديث معه بصداقة تدرك أنّها باتت أعمق وأجمل وأقلّ رسمية، يعززها بنفسه لحظة وداعك "هات قبلة"، قبلة على الخد تشبه المصافحة، تترك بصمات لا تمحى على الكفّ والقلب معاً.
لم أسمع كلمة "أحبك" من أمي أو أبي
لاحظت من خلال قصائدك الكثيرة أنّ والدتك حاضرة أكثر من أبيك، أو بالأحرى هذا هو الانطباع العام، نشعر أنّنا لا نعرف أباك بقدر ما نعرف أمك، ماذا عن العلاقة بالأب؟
أحبّ أن أصحح هذا الانطباع، فأبي حاضر حضوراً واضحاً ومبكراً في شعري، حضوره مرافق لحضور والدتي، مثلاً في "عاشق من فلسطين" هناك قصيدة مهداة إليه، "نهاني عن السفر"، في "أرى ما أريد"، وهناك مرثية طويلة له "ربّ الأيائل يا أبي"، وفي "لماذا تركت الحصان وحيداً" هناك ثلاثية حوار بين الأب والابن خلال الهجرة الأولى إلى لبنان، فمن ناحية الكمية هو حاضر أكثر، أو على الأقل، حاضر بشكل موازٍ لحضور أمي.
علاقتي بأبي كانت، كما يقول شعري، علاقة يلتبس فيها من هو الأب ومن هو الابن، وهذا أقوله في "ربّ الأيائل يا أبي"، كان أبي رجلاً خجولاً جداً، يعاملنا بمسافة، وكان أيضاً رجلاً حزيناً، لأنّ هموم الحياة انقضّت عليه باكراً جداً حين انتقل من مالك أرض إلى عامل في أرض، وحمل أعباء عائلة كبيرة، وهو من طبعه أنّه لم يوبخ أحداً منّا، بينما الشخصية الأقوى في البيت، والتي كنت أعتبرها عنيفة إلى حدٍّ ما، هي والدتي، وكنت أعتقد طفلاً، ونتيجة ما كنت أعتبره معاملة قاسية منها، أنّها لا تحبني، وبقيت هذه الفكرة معي إلى أن سجنت للمرة الأولى، وعندها أدركت أنّها تحبني، بل أدركت كم تحبني.
الشخصية الأقوى في البيت، والتي كنت أعتبرها عنيفة إلى حدٍّ ما، هي والدتي، وكنت أعتقد طفلاً، أنّها لا تحبني، وبقيت هذه الفكرة معي إلى أن سجنت للمرة الأولى، وعندها أدركت كم تحبني
في أيّ حال لم يكن سلوك أمي أو أبي بالمستغرب؛ إذ من عادات القرويين في ذلك الزمن ألّا يعبّروا عن حبهم وعاطفتهم تجاه بعضهم البعض، لم يكن اعتيادياً، كما نرى اليوم، أن يعبّر الأب والأم عن حبهما لأبنائهما، وكأنّ الحب عيب، أمر ينبغي إخفاؤه في المناطق القصية من المشاعر.
أليس هناك كلمة "أحبك" مثلاً؟
إطلاقاً، هذه الكلمة لم أسمعها حتى الآن لا من أمي ولا من أبي، حتى في طفولتي لا أتذكرها، بالتأكيد قالاها لي وأنا أصغر من أن أعيها، وهذا الخجل بين أبي وأبنائه توارثناه نحن الأبناء، فنحن الأخوة لا نحكي مع بعضنا بعضاً في أيّ قضية شخصية أو حميمية، نحكي في القضايا العامة، عائلة خجولة جداً، وعلى سبيل المثال لاحظت أنّ بنات أخي الأكبر يشتكين لي أنّه لا يحكي معهن ولا يتدخل في شؤونهن، هو مدير المدرسة التي يتعلمن فيها، ولكنّه لا يساعدهن ولا يسألهن عن دروسهن، ولا يحدثهن في أمورهن الخاصة، نوع من الانفصال العاطفي، لكنّه لا يعني أنّ أخي غير عاطفي، لكن ليس هناك تعبير عن العاطفة، إضافة إلى أنّه بسبب موقعه كمدير مدرسة يضطر إلى أن يكون محايداً، هذا النوع من العاطفة المكبوتة أظن أنّه من ميراث ثقافة قروية عربية، وبالنسبة إلى الوضع الفلسطيني تجده يتفاقم؛ إذ يكون الأهم بالنسبة إلى الأب مثلاً أن يحمي أولاده، وهذا يتضمن أحياناً أن يفر بهم إلى أماكن آمنة، كما حصل في هجرتنا الأولى، وأن يؤمّن لهم حياتهم؛ أي أن يضطلع بمسؤولياته كأب، ويأتي ذلك غالباً على حساب العاطفة المباشرة، لكن كما قلت لك علاقتي بأبي نمت لاحقاً، مع تقدم وعيي، وحيث بت قادراً على فهم حكاية أبي، والنفاذ منها إلى عالمه الداخلي، هذا الفهم الذي ترجمته شعراً.
جدّي أبي الروحي
في غياب هذا النوع من العلاقة مع الأم والأب، ألم يكن هناك من هو قريب منك عاطفياً، الخالة أو الخال مثلاً؟
جدّي كان الأقرب إليّ، وأعتبره أبي الروحي والعاطفي، كان يدللني صغيراً، ويصطحبني معه أينما يذهب، هو أخذني إلى عكا وإلى القرى المجاورة، وكان يصطحبني معه أيضاً إلى منزل صديقه الأعز وهو خوري القرية، وكان يجلسني في مجلسه، وهو مجلس جليل ضخم في غرفة مغلقة وكانت ممتنعة على الآخرين، وكان في هذه الغرفة كتب تراثية، وكان يفتخر جدي بكوني أستطيع القراءة وأنا في تلك السن المبكرة، قرابة (6) أعوام، ويجعلني أقرأ أمام أصدقائه، وجلسائه، وكان يهديني الكتب أحياناً، وهو مثلاً من جعلني أقرأ حكايات جاليفر أوليفرتويست، وأهداني مجموعة شكسبيريات مبسطة للأولاد، وكان كلما ذهب إلى المدينة، أحضر لي هدية كتاباً.
هل كان يتوسم فيك شيئاً؟
لا أعرف، لكنّه كان يفرح بقدرتي على القراءة، وحين هاجرنا إلى لبنان، وكان معنا، كان يعطيني الصحيفة كي أقرأها بصوت عالٍ.
هل كتبت شيئاً لجدك؟
بطريقة غير مباشرة في السيرة، وجميع العلاقات على هذا المستوى عبّرت عنها في هذه السيرة الشعرية، ولاسيما "لماذا تركت الحصان وحيداً".
كيف تصف نفسك في تلك المرحلة المبكرة؟ هل كنت هشاً أو ضعيفاً بين الأولاد؟ هل كنت تخجل من نفسك مثلاً؟
لم أكن مشاغباً، كنت سليط اللسان وسريع البديهة، وهاتان صفتان أخذتهما عن أمي، لكنّني جسدياً كنت ضعيفاً، وكان هذا يرشحني دائماً للتعرض لاعتداءات من أولاد آخرين، حين ولدت كنت ضعيفاً جداً، وكان يفترض ألّا أعيش، وقال الطبيب إنّ حياتي لن تستمر إلا أياماً، فكنت أتصدى للأولاد بسلاطة لساني، وبما افترضته تفوقاً عليهم في منطقة بعيدة عنهم، أي من خلال القراءات، كنت أحاول التميز عنهم بأنّني غير مشغول مثلهم بالألعاب، وأذكر مثلاً أنّني قرأت باكراً لطه حسين، وكان هاجسي الأول إثبات وجودي بتفوق ذهني، لأنّني لا أملك إمكانية المبارزة على المستوى الجسدي.
ذكريات جارحة
هل لديك ذكريات جارحة أو قاسية من تلك المرحلة؟ أعني هناك ذكريات من الطفولة ترافقنا طويلاً، وهذه عادة لا ينتبه إليها الكبار باعتبار أنّها هامشية أو اعتيادية.
بين ذكرياتي الجارحة أذكر ذات مرة حين كنت عائداً من المدرسة أوقفني ولد في صف أعلى منّي وضربني بلا أيّ سبب أو مقدمات... شعرت بالانسحاق، لا للألم، بل الإهانة، وممّا زاد شعوري بالإهانة أنّني غير قادر على الرد عليه، لأنّه أكبر وأقوى مني...، وعيي هذا الأمر كان يؤلمني، وما أنقذني من هذا الموقف هو أحد المعلمين الذي كان مارّاً من هناك، فأخذني من يدي وحاول أن يواسيني.
ما يؤلم في حالة كهذه هو الانكشاف، أي انكشاف الضعف أمام الآخرين وافتقاد الأدوات للمقاومة أو التعويض عن النفس.
تماماً، الإهانة هي أكثر ما آلمني، أن يعتدي عليّ شخص من دون أيّ سبب، ولا أستطيع الرد عليه، وهذا الجرح المبكر الذي لم يندمل ساهم في إدخالي في عزلة مبكرة، حيث كنت آخذ كتاباً وأذهب إلى حرش الزيتون وأقرأ وحيداً. مرة أخرى شعرت بإهانة مبكرة هنا في لبنان إبّان الهجرة الأولى... شُتِمت مرة أو مرتين بكلمة لا أعرف معناها، بنات لبنانيات في الصف قلن لي "لاجئ"، ولم أكن أعرف معنى هذه الكلمة. وحين عدنا إلى فلسطين أهنت بهذه الكلمة مرة أخرى من فتاة كنّا لاجئين في قريتهم، وكان هناك تنافس مدرسي بيني وبينها، وكنت متفوقاً عليها، فقالت لي: "أنت لاجئ"، وإذاً لعنة اللاجئ أو شتيمة اللاجئ ليست فقط خارج فلسطين، فداخل فلسطين هناك اللعنة نفسها.
ما يزال حتى الآن هناك لاجئون في فلسطين نفسها.
للأسف، فأنت تجد لاجئاً عن بلدته أو مدينته أحياناً في جوار البلدة أو المدينة نفسها، فأن تكون لاجئاً بداية هو ألّا يكون لك بيت تستظله، أن تقيم في خيمة حتى لو كانت هذه الخيمة تبعد أمتاراً عن بيتك، أو أن تقيم في منزل مستعار ومؤقت، هاتان الحادثتان؛ أي الضرب والشتيمة، كانتا من بين أكثر الأشياء المؤلمة في حياتي، وأظن أنّهما ساهمتا إلى حدٍّ بعيد في تحديد مسار حياتي ووعيي.
هشاشة وضعف
هذا النوع من الهشاشة والضعف هل أمدّك بنوع من الحاسة السادسة المبكرة تجاه معاناة الآخرين تجاه ضعفهم وهشاشتهم؟
لا أستطيع وصف الأمر كذلك، لم أعط هذا المعنى، كنت أشعر بأنّني أنا الهش، وكنت أعالج هشاشتي كما قلت بمحاولة التميز والتفوق في مجالات أخرى، لاحقاً صرت أعي أنّ هذه الإهانات هي في واقع الأمر غيرة، وصرت أشعر بأنّهم هم الأضعف، وابتدأ عندي بالتدريج أنّ من يظلمك إنّما هو يغطي هشاشته الداخلية.
أظن أنّ الشعر جاء في تلك المرحلة؟
لم أكن في تلك السن أعي قوة الشعر والكلمات بصورة عامة، كنت أقرأ وأكتب أحياناً من دون الانتباه حتى إلى أنّني أكتب شعراً، كان الشعر، كما القراءة، جزءاً من عالمي الخاص والحميم، وفي إحدى المرات، فيما يسميه الإسرائيليون عيد استقلالهم؛ أي نكبتنا، طلب إليّ مدير مدرسة قريتنا دير الأسد إلقاء قصيدة بالمناسبة، فكتبت وقتذاك قصيدة، من دون أن أعي أنّها قصيدة، هي في واقع الأمر رسالة إلى ولد يهودي، أقول له فيها بما معناه: إنّك اليوم تفرح، وأنا أحزن، تُعيّد بينما الدموع تنساب من عيني، وإنّه لا يمكن أن يكون عيداً بالنسبة إليّ إلا حين أشعر بما تشعر به، أي حين يتحقق لي ما هو متحقق لك، قرأت القصيدة في الحفل، فإذا بي أفاجأ بعد انتهائي بمختار القرية مستاء جداً، وقال بما معناه: هذا اللاجئ يريد أن يوقعنا في المشاكل.
اللاجئ مرة أخرى؟
الشتيمة نفسها، المهم أنّني لم أكن أدرك أنّ ما قلته يمكن أن يعني أحداً أو أنّه شعر.
أكان موزوناً مقفّى؟
أجل، لكن من دون تقصّد كتابة الشعر، كنت أقوم بما يشبه الواجب المدرسي أو فرض الإنشاء...، لكنّني فوجئت باستحسان أهالي القرية، أي الأناس العاديين، للقصيدة، وكأنّها جاءت لتعبّر عن مشاعر مكتومة عندهم، لكن ما فاجأني أكثر هو استدعاء الحاكم العسكري لي وتهديده المباشر لي بالتوقف عن كتابة مثل هذه الأشياء، وإلا فإنّ العاقبة ستكون كبيرة، كأن يمنعوا أبي من العمل، عدت إلى البيت ولديّ شعور مختلط بالخوف على أهلي، وفي الوقت نفسه بأنّ ما قلته، الشعر، ليس بالأمر البسيط، وأنّه يمكن أن يزعج حاكماً عسكرياً إلى درجة تجعله يهدد ولداً مثلي.
محاكاته الأولى
في هذه القصيدة المبكرة مَن كنت تحاكي؟ مَن كان مثالك أو نموذجك بين الشعراء أو الأدباء؟
كنت متعرفاً على الشعر المهجري، والأرجح على الشعر الأندلسي، إضافة إلى الشعر الجاهلي، وأذكر أنّني سُحرت بالمعلقات، وأوّل ما طمحت إلى كتابته فتيّاً هو معلقة شعرية، لم يكن الشعر العربي الحديث قد وصلنا بعد، السياب أو البياتي أو شعراء التفعيلة.
لم تكن تعرّفت على الشعر العبري؟
ليس بعد، الشعر العبري تعرّفت عليه لاحقاً.
من هم الشعراء الحديثون الذين تعرّفت عليهم بداية؟
كانوا (3) بشكل أساسي؛ محمود حسن إسماعيل وعبد الوهاب البياتي ونزار قباني، وكنّا نتصارع في المدرسة حول هؤلاء الشعراء، وكانت الانتماءات السياسية، من يمين ويسار، تنعكس في الانجذاب لهذا الشاعر أو ذاك، فينتقل أحدنا مثلاً من محمود حسن إسماعيل إلى البياتي، ثم تتعمق علاقته بناظم حكمت.
ماذا عن نزار قباني؟
نزار قباني كان خارج هذا المعنى، كان فوق التجارب السياسية والحزبية، كان يخاطب مراهقتنا، والمراهقة واحدة سواء كنت يسارياً أم يمينياً، فتنني نزار قباني في أنّ هناك أشياء لا تقال كان يقولها؛ أي أنّ الشعر يستطيع قول كل شيء، علّمني نزار قباني أنّ الشعر ليس له هيبة، يمكن أن تشتغل قصيدة من بنطال، وأنّ مفرداته ليست مستعصية، وأنّ ما نعيشه يمكن أن نحكيه ببساطة تامة، فكنت أنتقل بين هؤلاء الشعراء الـ (3) الذين ذكرتهم.
تحدثنا عن عالمك الداخلي كطفل، مع المراهقة هل كنت تنظر إلى شكلك؟ هل كنت تجد نفسك وسيماً مثلاً؟
أعي أنّ البنات كنّ يحببنني، كان شعري أشقر، ولكن لم أكن أظن أنّ شكلي جميل، ولكنّي كنت أحب أن يكون لي حظوة لدى الفتيات، بمعنى أنّني كنت مثل لعبة البنات، يغنجنني وربما كنت أسليهن، لأنّني كنت سليط اللسان وجريئاً.
كيف هو شكل الحب في مجتمع قروي محافظ كالذي نشأت فيه؟
الحب كان يتم عبر تبادل الرسائل، لم تكن هناك قصص حب بل قصص وصال، فالرسالة كانت أقرب إلى الزواج الرومانسي، وكنّا نفكر بالرسالة كثيراً وننشغل بها… إلخ، أمّا التفكير في الجنس، فلم يكن ممكناً.
متى بدأت تفكر بالجنس؟
لديّ مجموعة حب أول وليس حباً واحداً، والمطلب الجنسي لم يكن وارداً لديّ أو لدى أصحابي، كنّا صغاراً، ولم يكن لدينا هذا النداء الجنسي الملحّ.
فن وسياسة
أكنت تشاهد السينما؟
كنّا نشاهد الأفلام الهندية بشكل أساسي وأفلام الكاراتيه وأفلام فريد الأطرش، الأستاذ وحيد.
هل كان يجذبك عبد الحليم حافظ؟
كثيراً، كما كانت هناك أحزاب شعرية كان هناك حزبان في الغناء؛ حزب عبد الحليم حافظ وحزب فريد الاطرش، وكنت متعصباً لعبد الحليم إلى درجة أنّني كنت أرفض الاستماع إلى فريد الأطرش، الآن أجد أنّ صوت فريد الأطرش جميل، وكذلك ألحانه جميلة، لكن وقتذاك كنت متعصباً والتعصب يُعمي، ومثلما يصيب الدماغ والعين والقلب يصيب الأذن أيضاً.
ماذا عن وجهتك السياسية وقتذاك؟
كنت متأرجحاً بين الناصرية والحزب الشيوعي.
لماذا عبد الناصر؟
ببساطة لأنّه كان زعيم العرب ومنقذ الأمّة، لكن على مستوى الداخل كان انجذابي إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي كان يطرح قضايانا ويدافع عنّا كأقلية ضمن المجتمع الإسرائيلي، كنّا نعتبره حزبنا والمدافع عنّا، وكنّا منسجمين جداً في إطار هذا الحزب، من دون أن نكون بعد إيديولوجيين، بمعنى أنّه لم يكن لدينا فهم بعد للماركسية وأطروحاتها...، ولم يكن هناك تعارض بين حبنا للحزب الشيوعي وحبنا لعبد الناصر، وحين حصل الخلاف لاحقاً بين الناصرية والحزب الشيوعي كنّا مشتتين، كنّا ننحاز إلى هذا الطرف أو ذاك، لكن لم تكن لدينا الحجج التي ندافع فيها عن هذا أو ذاك.
ألم تأخذ خياراً؟
لا، لم أتمكن من ذلك.
لكنّك بقيت في الحزب الشيوعي؟
لعدة أعوام، لكن لم يكن الخلاف حادّاً، وحين يخطب عبد الناصر كان الجميع يبحثون عن راديو للاستماع إليه، كان الراديو نادراً أيضاً.
متى سمعت كلمة فلسطين للمرة الأولى، أنت الذي نشأت ضمن المجتمع الإسرائيلي؟
كأقلية كان الإسرائيليون يعاملوننا كعرب، رفضهم واضطهادهم لنا كان على أساس أنّنا عرب، كان إدراكنا إذن لعروبتنا، ومن هنا كتبت "سجّل أنا عربي، وليس "سجّل أنا فلسطيني". كنّا نعرف أنّ هناك بلاداً اسمها فلسطين، لكن لم يكن هناك مشروع اسمه فلسطين، أو كيانية اسمها فلسطين، يكفي أن تقول أنا عربي من دون الحاجة إلى التعريف الفلسطيني، بدأت الفكرة الفلسطينية تنمو بعد نشوء منظمة التحرير الفلسطينية.
بعد هزيمة 1967؟
على أنقاض هذه الهزيمة العربية كان على الفلسطيني أن ينتبه إلى فلسطينيته، وأن يأخذ أمره بيديه. لكن الآن أنتبه إلى أنّ مجموعتي الشعرية الثانية كانت بعنوان "عاشق من فلسطين"، ولا أعرف من أين جاءني هذا التأكيد على الشيء الفلسطيني، خاصة كما قلت لك أنّنا كنّا ننظر إلى أنفسنا كما كان الإسرائيليون ينظرون إلينا كعرب.
سجّل أنا عربي
"سجّل أنا عربي" إحدى أبرز قصائدك المبكرة والأكثر شهرة، هناك من يقول إنّك لا تحب هذه القصيدة، وتتمنّى لو أنّك لم تكتبها.
هذا غير دقيق، مشكلتي ليست مع القصيدة إنّما مع قارئها، أي أنّ محمولها، السياسي والرمزي، لا يشكّل عبئاً عليّ، لكن المشكلة هي مع القارئ الذي يتعامل معها على أنّها بطاقة هويتي الشعرية، أي أنّ محمود درويش يعني بالنسبة إليّ قارئاً معيّناً "سجل أنا عربي" حصراً، ولا يعرفني حتى الآن إلا بها... وسأحكي لك بصراحة حكاية هذه القصيدة التي تضعها في سياقها الفعلي، فقد ذهبت إلى وزارة الداخلية لاستصدار بطاقة هوية أو لتجديدها، لا أذكر على وجه التحديد، وكان هناك استمارة على الموظف أن يملأها، وتتعلق بمعلومات عنّي، عن مكان سكني وعن ولادتي… إلخ، إلى أن سألني الموظف: "القومية"؟ أجبته: "عربي"، فعاود السؤال وكأنّما في نبرة السؤال وفي إعادته على هذا النحو استنكار، فقلت له مجدداً وكان الحوار يجري بالعبرية: "سجّل أنا عربي"، خرجت من عند الموظف، وأعجبني الإيقاع فبدأت في رأسي بتدوين القصيدة قبل أن أكتبها على قصاصة ورق في الباص في طريقي إلى البيت، وكان بناء القصيدة يشبه الاستمارة؛ أي صفاتي والمعلومات المتعلقة بي، لكنّ الشعر لم يعد أشقر، بل بات أسود، وباتت كفي "صلبة كالصخر"، وبات عدد أولادي ثمانية، كردٍّ على الموظف؛ أي الذهنية الإسرائيلية، التي يغيظها كثرة أولادنا، حشدت في القصيدة كلّ ما يغيظ هذه الذهنية، صرت أطور بطاقة هويتي الشخصية وأوسعها لتصبح بطاقة هويتي الجماعية، وجاء ذلك كله بشكل عفوي، وعلى شكل ملاحظات سريعة، وكتبتها كخاطرة لا كمشروع قصيدة.
هل كتبتها على القافية؟
على عدة أوزان وقوافٍ، لكن لم يهمني أن تكون قصيدة، أردتها صرخة تحدٍّ...، تركت هذه القصاصة جانباً ولم أعرها الكثير من الاهتمام، إلى أن كان هناك مهرجان شعري في الناصرة يفترض أن أشارك فيه بقصيدة، ذهبت وألقيت قصيدة، ولأنّي كنت صغيراً، وكما يقولون اليوم هناك مطرب جديد صاعد، كانوا يقولون هناك شاعر جديد صاعد... يقول كلاماً، وكنت أحياناً أصعد المنبر بالشورت، لم يكن هناك علاقة بين شكلي ونصّي، بسبب ذلك طلب الجمهور إليّ إلقاء قصيدة ثانية ولم يكن لدي، لكن في جيبي نص "سجل أنا عربي" فألقيتها، وحدث ما لم أكن أتوقعه، شيء يشبه الكهرباء شاع في الجو، إلى حدّ أنّ الجمهور طلب مني إعادة القصيدة (3) مرات، يبدو إذن أنّني كنت أعبّر عن مكبوت بسيط جداً، لكن غير مُعبَّر عنه.
كان شعورك العفوي حين كتبت.
تماماً، لكن أقولها لك بصراحة من قرر أنّ هذه قصيدة هم الناس وليس أنا... هم الذين قالوا لي هذا شعر، أنا كنت أسميه نصاً قبل أن يشيع مفهوم النص، من يومها وأينما أذهب يثار هذا الموضوع، ويطلب منّي إلقاء هذه القصيدة، وهذا المطلب يتجاهل أنّني مررت بتجربة جديدة، دخلت مع "العصافير تموت في الجليل"، في الغنائية الخافتة "مطر ناعم في خريف بعيد".
أي ليس الجملة الضاربة، بل النص المشغول.
أي البحث عن الشعر، ولكن هذه القصيدة كانت دائماً بمثابة العقبة.
هل طاردتك؟
تماماً، هنا في بيروت أو في العالم العربي... فكنت أخاف من أن تشكّل عائقاً يمنع القارئ من متابعتي.
لكن رغم ذلك، للقصيدة فضل كبير عليك.
لا أنكر ذلك، فهي التي عرّفت الناس عليّ، لكن هذا لا يعني أن أبقى، أو أن يبقى شعري، أسيرها.
أحنّ إلى خبز أمي
هناك قصيدة أخرى لا تقلّ شهرة عن "سجل أنا عربي" هي "أحنّ إلى خبز أمي"، وهي أيضاً من بين القصائد التي تُطلب باستمرار منك، حتى إنّك في أمسية البلمند أخيراً نصبت فخاً للجمهور بأن قلت مطلع القصيدة، لكن يبدو أنّ هذه القصيدة لا تشكّل عبئاً عليك؟
لا تزعجني، وسرّ انتشار هذه القصيدة أنّها غُنّيت، ولو بقيت قصيدة في كتاب، لكان التعامل معها اختلف.
لكن هناك قصائد أخرى غنيت، ومع ذلك لا تحوز الشهرة نفسها أو الموقع نفسه عند الناس.
هذا صحيح فـ "سجّل أنا عربي" غنيت مرات عدة، وصنعت غناء سيمفونياً، فكانت القصيدة أهم من الأغنية، قوتها كانت في ذاتها وصارت خطراً عليّ وعلى تطوري، إذ أرادني الناس أن أكون أسير هذا المناخ التعبيري، لكنّ غناء قصيدة "أمي" من ناحية أخرى خدم القصيدة، وتعرّف الناس على وجه آخر لي ولعبارتي الشعرية.
لديك مشكلة في تكرار المناخ أو العبارة نفسها، هناك شعراء يبقون أسرى التطلب الجماهيري.
هذه مشكلة، وأنا أقول دائماً لا أحد ينجو من التكرار، وألّا تكون القصيدة فعلاً عمل وحي، أي إنّ الشعراء الأنبياء فاتحون خطاً مباشراً مع الغيب... لا أحد ينجو من التقليد خاصة في البدايات، حيث لا تكون شخصيته الشعرية قد تكونت بعد، وأنا لا أرى خطراً في التقليد، الخطر الحقيقي هو أن يقلد الشاعر نفسه؛ إذ إنّ تقليد الذات، خاصة مع بلوغ النضج، هو تعبير عن عجز لا عن طموح، وعودة إلى الخلف وتجمّد، تقليد الآخر هو عبارة عن تقدم وطموح، أضف إلى ذلك أنّ تقليد الذات واعٍ، أمّا تقليد الآخر، فغير واعٍ دائماً، أحياناً تدخل قراءاتك إلى نصك، حتى من دون أن تدري.
ليس الشاعر وحده هو المسؤول، فهناك الجمهور الذي يحبس الشاعر في تعريف واحد وإطار واحد، وبالتالي يشعر الشاعر بأنّه إذا خرج من هذا الإطار سينتهي، أي أنّ هناك تواطؤاً بين الشاعر والذائقة العامة؟
لكنّ الذائقة العامة ليست نهائية، أنت تصنع الذائقة العامة، الشعراء يصنعون هذه الذائقة ويطورونها ويبدلون في مساراتها، فإذا لم تضف شيئاً استفزازياً حتى على نصك، فلن تتغير هذه الذائقة، فالذائقة العامة تجاه نص كل شاعر، وأتحدث عن نفسي هنا، إذ هناك علاقة خاصة بيني وبين جمهوري.
هل هناك توقع دائم؟
إذن، أنا السيد في التحكم بهذه الذائقة، وواجبي أن أغير هذه الذائقة، أمّا حين نتحدث عن تغيير الذائقة العامة بشكل عام، فهناك صعوبة وتحتاج بالتالي إلى حركة شعرية كاملة تساعد على التغيير، لذلك أتحدث عن علاقة محددة بين شاعر معيّن وجمهور أختاره بشكل حر وتلقائي، على هذا الشاعر أن يقدّم باستمرار اقتراحات مقنعة لهذا الجمهور بأنّه ما يزال مرتبطاً به، وأنّ العقد بينهما لم ينفرط... أنا أخاطب باستمرار جمهوري هذا وأقول له: حسناً احترم ما تعرفه، لكن اقترح عليك تغييره، لأنّ التوقف جمود والجمود موت، وأنا أكبر في وعيي وثقافتي ومشروعي وفهمي للشعر... هذا تخصصي أيّها القراء وليس تخصصكم، أنتم تمارسون مهناً أخرى، لذا اسمحوا لي أن اقترح عليكم شيئاً آخر، بالتالي، الصدمة مطلوبة دائماً، وقد تستغرب في تجربتي أنّ كل نص يثير صدمة لدى القارئ بسبب انزياحه بهذه الدرجة أو تلك عمّا يعرفه، ثم يأتي نص بعده فتجد القارئ يطالبني بالنص السابق الذي أثار من قبل عنده صدمة، وإذن أنا أقوم بتراكمات أساسها الحقيقي أنّ هناك ثقة بيني وبين قارئي، وقارئي ليس واحداً بل يتحول، هناك باستمرار قارئ جديد، وأنا ألاحظ أنّ قاعدة قرائي تتوسع، لأنّ النخبة في العالم العربي تتوسع بدورها.
في أيّ حال هذا ما جعل أعمالك الأخيرة تجد قبولاً واسعاً، على الرغم من أنّها تقوم على أرضية مختلفة؟
قد تستغرب أنّني اليوم أكثر توزيعاً وانتشاراً، لأنّ النخبة كبرت والقارئ النوعي كثر، ثم إنّني أقنعت قرائي بأنّني في الجوهر لم أتغير، لكن أنا لديّ طموح شعري مستمر، لذلك أقول إنّ إنجازي الأكبر ليس في إيقاعاتي ولا تراكيبي، بل في قدرتي على التواصل مع قارئ جديد ومختلف، وعليّ أن أصطحب هذا القارئ في رحلتي وطموحي الشعريين، فقد بات هو نفسه يطالبني بالتطور والتغيير المستمرين، لا أتوقع بالتالي أن يكون قارئ "سجّل أنا عربي" هو قارئ "الجدارية"، أصبح هناك قارئ آخر، "سجّل أنا عربي" راح، وحلّ محله قارئ آخر.
لكنّ القارئ الأول ما زال موجوداً.
بطبيعة الحال، لأنّك حين تقول قارئي لا تتكلم عن شخص، فهناك أشخاص تغيروا، هناك أشخاص ترجلوا من القطار وصعد آخرون، هناك أناس صعدوا في المحطة الأولى، وغيرهم في الثانية، وغيرهم في الثالثة… إلخ.
بكيت كثيراً.. ولا أعرف رأي أمي بشعري
منذ منتصف الستينات بتّ شاعراً معروفاً في العالم العربي، والاعتراف بك وتقديرك في تزايد مستمر من ذلك الوقت، أحب أن أعرف متى بدأ أمّك وأبوك، وأهلك وعائلتك، بالنظر إليك بتقدير، إذ يحدث أحياناً أن نكون مقدّرين على نطاق واسع، لكنّ عائلتنا لا تقدّرنا على النحو نفسه، متى بدأت تشعر بأنّك مهم، أو لك معنى في عيون أهلك بالذات؟
منذ بدأت بدخول السجن، أهلي كانوا يعرفون أنّني أكتب الشعر وأعمل في الصحافة، لكنّ شعورهم بأنّ ما أقوم به مؤثر هو حين بدأت بدخول السجن، وحين وضعت في الإقامة الجبرية صاروا يعاملونني كشخص له وزن، ولاحقاً صاروا يسمعون شعري في الإذاعات، فأدركوا أنّني شخص مهم نوعاً ما، وأعتقد أنّهم بدؤوا يقدّرونني منذ ذلك الوقت، لكنّهم لا يعبّرون بالضرورة عن ذلك.
هل كانت لديهم مشكلة بسبب خلفيتهم الثقافية والاجتماعية مع كونك شيوعياً؟
إطلاقاً، لم يكن لكلمة شيوعي معناها الإيديولوجي، وإنّما هو معنى نضالي ووطني.
يتبادر إليّ الآن أنّنا لا نعرف الكثير عن دراستك.
أنا لم أتلقَّ دراسة جامعية، إذ توقفت عن الدراسة في الثانوية، وذلك للأسباب التي ذكرتها، وأيضاً لأنّه لم يكن في مقدور أبي تعليمنا جميعاً بسبب الكلفة العالية للتعليم في إسرائيل... بالتالي كان عليّ أن أعلّم نفسي بنفسي من خلال القراءات...، والمفارقة أنّني دخلت الجامعة لاحقاً لإعطاء المحاضرات، لكنّني لم أدخلها تلميذاً.
أمّك قرأت بالتأكيد أو سمعت "أحن إلى خبز أمي"، لكنّنا لا نعرف رد فعل أمّك عليها؟
ولا أنا، حتى الآن لا أعرف.
ألم تسألها؟
ولا مرة، لا تجيب...، لكنّ أخواتي قلن لي إنّها تفرح حين أكتب لها خاصة حين أسميها بالاسم كما في "تعاليم حورية"... علاقة أخواتي البنات بها مختلفة عن علاقتنا نحن الذكور بها، وهنّ ينادينها باسمها الأول، رافعات الكلفة معها، وهنّ يخبرنني أنّها تفرح كثيراً، لكنّها لا تعبّر عن ذلك أمامي.
هل تدرك أنّها بعد قصيدتك لها باتت أمّاً استثنائية؟
لا أعرف شعورها، مع أنّها سليطة اللسان ولاذعة ودمها خفيف، لكنّها لا تفصح بسهولة عن عالمها الداخلي.
هل يحزنك أنّها كبرت؟
لا، كبرتْ أمي في غيابي مثلما كبرتُ في غيابها، ولا تنسَ أنّنا لم نرَ بعضنا البعض قرابة (30) عاماً.
إطلاقاً؟
كانت علاقتنا مقتصرة على المخابرات الهاتفية، ومرة رأيتها في القاهرة.
كيف تصف مشهد عودتك بعد هذا الغياب الطويل واستقبال أمّك لك؟
حرصت لدى زيارتي الأولى لمناسبة المشاركة في تأبين إميل حبيبي على أن يكون دخولي صامتاً أو متوارياً، لذلك ذهبت إلى البيت ليلاً، وقلت لأخي بألّا يخبر أحداً بأنّني ذاهب إلى البيت، لكن حال وصولي إلى البيت ورؤية أمي لي، راحت تزغرد، وكان هذا إشعاراً للبلدة كلها بأنّي رجعت.
هل بكيت؟
خبأت دموعي.
هل بكيت كثيراً في حياتك؟
كثيراً، وما أزال أبكي.
تبكي، أي تذرف الدموع أم تخفيها؟
أذرف الدموع.
ما الذي يبكيك؟
أشياء كثيرة، أحياناً حين أشاهد التلفزيون وأرى مشاهد الانتفاضة، مشهد محمد الدرة أبكاني مثلاً، وقد يفاجئك أنّ الأفلام العاطفية القديمة تبكيني.
متى بكيت آخر مرة؟
قد يفاجئك هذا، لكنّني بكيت هنا في لبنان خلال أمسية البلمند، فخلال إلقائي المقطع الذي أقول فيه: "وأنا وقد امتلأت بكل أسباب الرحيل/ فأنا لست لي/ أنا لست لي"، وحين وصلت إلى العبارة الأخيرة غالبتني الدموع، وفاجأتني ووجدتني أدير وجهي إلى الجهة الأخرى لكيلا يرى الحضور ذلك. وهذه ربما هي المرة الثانية التي أبكي فيها على المنبر، ففي تونس في الثمانينات فاجأني البكاء أيضاً، وبعض الذين كانوا حاضرين تلك الليلة قالوا لاحقاً: إنّ هيئة البكاء كانت بادية عليّ منذ اللحظة الأولى لاعتلائي المنبر، لكنّ أول بكاء جارف وغزير كان في 1967.
وقت الهزيمة؟
مع طقس دخول دايان إلى القدس، بدا المشهد أكبر من احتمالي، ووجدتني منخرطاً في بكاء عنيف شعرت معه أنّ جسدي كله يهتز معه، ولم أحسّ بالزمن وهو يهرّ عليّ على هذه الحالة.
علاقته بالشعر العبري
هناك شاعر أمريكي اختارك والشاعر اليهودي إيهودي مينوحين كشاعرين للسلام، كيف تصف علاقتك بالشعر اليهودي؟
ماذا تعني بالسلام؟
أعني أنّ هذا الشاعر الأمريكي اختار قصيدة لك ووضعها في مقابل قصيدة أخرى لمينوحين يعبّر فيها كلٌّ منكما ومن زاوية نظرته الخاصة عن توقه الخاص إلى السلام والحرية وعن علاقته بالأرض.
حسناً، علاقتي بالشعر العبري بدأت بطبيعة الحال من خلال الكتب المدرسية حين كان هناك عدد من الشعراء المقررين في المنهاج، لكنّني لم أكن أحب هذا الشعر، إذ كانت علاقتي به كعلاقة فضول، أحببت التوراة مثلاً، لأنّني وجدت فيها شعرية أكثر ممّا وجدت في شعر بياليك، الشاعر القومي في إسرائيل... لم أحبّ شعره بسبب قوميته الشديدة التي تفوق احتمال شخص مثلي، فهو يغنّي للمكان، لفلسطين، ويحنّ إليها، بحيث لا يبقى لي شيء في المكان.
هناك علاقة مبتورة أصلاً بهذا النوع من الشعر.
تماماً، فلغة بياليك تستولي على مكاني، وأنا أولي هذا الحب والحنين للأرض، منذ البداية إذاً هناك نوع من الجدار، وأنا نفسياً كنت دائماً ضد اختراق هذا الجدار، وبياليك هو شاعر مكشوف لا يضللك جمالياً، وبالتالي ما لفت نظري إلى الشعر العبري بعد المدرسة هو بالذات الشاعر الذي ذكرت، أي مينوحين، فهو شاعر كبير حقاً.
حزنت حين مات؟
أسفت، لأنّه ليس هناك علاقة بيني وبينه، وأنا التقيته مرتين عابرتين فقط، وكان أنيقاً ومهذباً، المرة الثانية كانت في نيويورك، واقتصر اللقاء على المصافحة، لكنّني رفضت جميع الدعوات إلى مهرجانات شعرية تجمعني به أو بسواه من الشعراء العبريين، وقد حاول أن يوسط بعض الأشخاص لكي أشارك، وكان هذا سبباً إضافياً لديّ للرفض.
ماذا عن العلاقة الشعرية به، فهو يكاد يكون الوجه المقابل لك في الجهة الأخرى؟
مينوحين شاعر بارع في إخفاء حسه الإيديولوجي، فهو يحاول أن يوظف اليومي والهامشي والإنساني مكان الأسطورة اليهودية، وبالتالي فإنّ شعره يقترح تعديلات شعرية على التوراة. فهو يفضل أن ينظر السياح إلى رجل عادي يحمل سلة خضار بدلاً من الآثار الرومانية، أي تسليط الضوء على إنسانية الإنسان، ولكن مع ذلك هو شاعر إيديولوجي، المشترك بيني وبينه هو أنّنا نتنافس، أو أنّ لغتي ولغته تتنافسان على المكان نفسه، هو يمتلك المكان بلغته، وأنا أمتلك المكان بلغتي، وحفريات لغتنا تلتقي أحياناً ونحن نحفر، لأنّنا نتصارع في نهاية الأمر على المكان نفسه، دائماً كنت أقول أتمنى أن تكون حروبنا حروباً لغوية وشعرية، ومن يملك جماليات أكثر، كنت أحبّ هذه المبارزة غير المقصودة بيننا، كنا دائماً نلتقي عند ذلك الفراق، أو نفترق عند ذلك اللقاء، لكنّه شاعر كبير بلا شك، وهو الشاعر الأهم في الأدب العبري الحديث.
تقول لريتا في "شتاء ريتا الطويل" من "أحد عشر كوكباً": ضاع يا ريتا الدليل/ الحب مثل الموت وعد لا يرد ولا يزول، وتحدثها عن لعنة الحب المحاصر بالمرايا، هل يحاصرك تأويل قصائدك الغرامية لريتا؟
أخشى أن يؤول الحب بصورة عامة إلى موضوع من خارجه، وقصيدة الحب عندي تمثل البعد الإنساني الذاتي شبه الوحيد القادر على التعبير عنه وسط الصفة التمثيلية التي تحمله، ولكنّني لا أستطيع أن أتحرر من ضغط التاريخ على المشاعر وعلى الهوية، وأحذر ألّا أحول المرأة إلى موضوع، أتعامل مع المرأة ككائن إنساني، وأجري معها حواراً شعرياً إنسانياً متكافئاً بين كائنين إنسانيين، للأسف في ريتا تتداخل نساء عدة، صارت ما يشبه الشيفرة، لذلك أقلعت تماماً عن الكتابة عنها لكيلا تتحول إلى "سجّل أنا عربي" عاطفية.
في "أنا يوسف يا أبي" من "ورد أقل" تقول: "إخوتي لا يحبونني"، هناك التباس قائم حول هؤلاء الإخوة، هل نستطيع أن نعرف من هم؟
هذا هو السؤال الوحيد الذي لا أريد الإجابة عنه، لأنّه يحرج إخوتي ويحرجني، ولكنّهم بالتأكيد ليسوا أشقائي، أي ليسوا إخوتي في العائلة.
أظنّ أنّ هذه إجابة.
ربما.
ارتبطت بصداقة بياسر عرفات، ألم يخفك ارتباط اسمك به؟
لا أعرف، لا يستطيع الشاعر أن يقول إنّه صديق لقائد أو حاكم، لأنّ الشروط غير متكافئة، ولكنّ تعاملي مع ياسر عرفات فيه الكثير من البعد الإنساني، وعنده من لياقة السلوك ما ينسيني أنّني أمام زعيم، بل أمام إنسان.
بعض الخبثاء يقول: إنّ "مديح الظل العالي" كُتبت له.
لا.
ظلّ من إذاً؟
هو ظلّ المقاتل والفدائي، وهذا واضح في القصيدة.
تأثره بهؤلاء الشعراء
هل تأثرت بالعمق بشعراء غربيين؟ بمعنى هل ثمّة من الشعراء الغربيين من تعتبره من روافد عبارتك الشعرية؟
بالطبع، لا يمكن فهم شعري إذا لم تفهم مرجعياته، أكثر شاعر تأثرت به في شبابي الشعري هو لوركا، تعلمت منه تغيير وظائف الحواس في اللغة، تعلمت الشفافية التعبيرية، أي كيف تستطيع جعل شيء ثقيل ومادي في غاية الخفة كالفراشات، لوركا أدخلني عالم الفراشات، كيف يصير البحر فراشة، والغابة فراشة، والمقعد فراشة، شاعر مائي بامتياز، شاعر آخر هو بابلو نيرودا علّمني سلوك الطرق الوعرة، تلك الغنائية المتصاعدة في رحلات كبيرة، على طرق الملاحم، صعود المنحدرات والجبال والعناصر.
بالنسبة إلى لوركا يبدو أحد أكثر الشعراء الذين التصقت صورتهم الشخصية بشعرهم، بمعنى أنّ سيرته وصورته هما رافدان إضافيان في قراءة شعره، هل تعلمت ذلك منه أيضاً، بمعنى هل طمحت إلى أن تكون صورتك على صورة شعرك؟
لم أتأثر بشخص لوركا، وحتى وقت لاحق بدأت في قراءة السير والانسحار بها، ومنها سيرة لوركا، لكنّ هذه المعادلة؛ أي الصورة والنص، لم تكن بين ما تعلمته من لوركا، علّمني شعره النبض الداخلي الذي يحيل الأشياء إلى خفة مطلقة كما قلت لك، ثم تعلمت مع نيرودا قوة الشكل، وأنّه لا حدود للاندفاعات الكبرى للشاعر، وهذه غير موجودة عند لوركا.
تحدثت في بداية حوارنا عن ناظم حكمت.
جذبتني إنسانيات ناظم حكمت، لكنّه خرج بسرعة منّي ربما لشدة ما أصبح موضة، لكن الآن استعدته، واكتشفت أنّ شعره في الواقع أهم من صورته في الشعر العربي، أهم بكثير.
ماذا عن ت. س. إليوت؟
من بين الشعراء الإنجليز سحرني إليوت بصورة خاصة، حاولت أن أكون أقرب عاطفياً إلى نص أودن، أن أعلّم نفسي حبه، بسبب يسارية هذا الأخير ويمينية أو محافظة إليوت، لكنّني ملت في النهاية إلى إليوت.
ما الذي أعجبك في نصه؟
إليوت منظومة شعرية كاملة، ومنه تعلمت تلك العلاقة الفريدة بين النثر والشعر، أي كيف يتحول الشعر إلى نثر الحياة، أي أنّ الشعر يتسع بنثر الحياة، أضف إلى أنّ إليوت صاحب مشروع يمكن اختصاره في نظريته الغامضة حول المعادل الموضوعي، أي حين يكون هناك شيء موضوعي، حدث ما، يخفف حدة اندفاع العواطف، النقد بشكل عام لم يجد حتى الآن تحليلاً كاملاً.
هناك شعور بأنّ إليوت بالنسبة إلى المتلقي العربي والحداثة العربية بقدر ما فتح أبواب الحداثة أقفل أخرى، بمعنى أنّ جزءاً كبيراً من الحداثة العربية علق عند حدود "الأرض الخراب".
هناك الكثير من التقويمات والإحصاءات التي تضع إليوت كأحد أكبر القامات الشعرية في عصرنا الحديث، المشكلة كما قلت في التلقي، إذ لا نستطيع أن نطالب إليوت بألّا يكون عظيماً إلى هذا الحد مثلاً.
هل تشعر بأنّك أقفلت أو فتحت أبواباً؟
لم أفعل في الشعر العربي ما فعله إليوت، لا أدّعي شيئاً من هذا النوع.
قرأت ازرا باوند؟
قرأته وتعبت في قراءته، باوند كمشروع شعري ونظرية أهم منه كإنجاز شعري، وهذه النظرية تتجلى في أناشيده، اقتراحات باوند الثقافية والشعرية أكبر بكثير من إنجازه الشعري.
موقفه من قصيدة النثر
ألم تدخل في سجالات مع قصيدة النثر؟
لا ينبغي لي فعل ذلك، هناك من اتهمني سابقاً بالعداء لقصيدة النثر، لكنّ الدليل الوحيد على "عدائي" لقصيدة النثر هو أنّني لم أكتبها، بالنسبة إليّ أهم ظاهرة شعرية وأهم اختراق شعري في العالم العربي تمثل في قصيدة النثر، لكن بقدر ما تطورت قصيدة النثر بسرعة بقدر ما دخلت بسرعة في أزمة، قصيدة النثر كإبداع ليست هي المشكلة، لكنّ المشكلة ربما أنّ قصيدة النثر لم تخلق نظامها.
لكنّها في طبيعتها ضد النظام؟
ضد النظام له نظام، إذ ليس هناك كتابة لا موسيقى من دون نظام، والنظام لا يحدده الفهم العام بل كل شاعر في حد ذاته، المشكلة الثانية في قصيدة النثر ليست في سؤال إبداعيتها أم لا، وأعتقد أنّ هذا السؤال حسم منذ زمن طويل، لكن في عصبويتها أحياناً. فقصيدة النثر تبالغ أحياناً في نفي كل ما عداها، وهي لا تعرف الشعر إلا اذا كان نثراً، ولا تعرف الحداثة إلا إذا كانت نثراً، أي أنّها أقفلت الخيارات الأخرى، وفهمت الإيقاع على أنّه لا يأتي إلا من الداخل. هذه مسألة للنقاش، فحتى الإيقاع الداخلي يمكن أن يأتي من الوزن، لمَ لا؟ فالإيقاع ليس المسطرة والقاعدة، بل طريقة تنفس الشاعر، خذ مثلاً معلقة امرئ القيس المكتوبة على وزن واحد، البحر الطويل، هذا الوزن فيه إيقاعات كثيرة، تتبدل بحسب تبدل نفس الشاعر وعبارته، إذن لماذا نعادي الوزن إلى هذا الحد؟ الوزن هو أداة قياس لا أكثر، والإيقاع يمكن أن يتشكّل من الوزن نفسه، لذلك الرفض المطلق في قصيدة النثر للتعامل مع إيقاع قادم أو مقاس بالوزن. أظن هذا ترفاً، لكن هذا لا ينفي أنّني أحب قصيدة النثر، وإذا قمنا بإحصائيات نجد أنّها الأكثر حضوراً.
هل فرضت عليك قصيدة النثر للسبب الذي ذكرت نوعاً من التحدي؟ أي بسبب الإقبال الواسع عليها هل خشيت أن يصبح شعرك خارج البوصلة؟
لم أخف، لكنّني اضطررت أن أقف إبداعياً في حالة دفاع، قصيدة النثر هي التي عادتني، وبالأحرى ليست قصيدة النثر، بل بعض شعرائها الذين اتخذوا موقفاً هجومياً، المعالجة هنا لم تكن سجالية أو نقدية، بل إبداعية، فما أحاول القيام به هو كتابة قصيدة نثر بالوزن، لكي أقول إنّ الوزن يستطيع قول كل شيء، ثم إنّني أحاول إجراء نوع من المصالحة، ولا يشكّل علي نظامي الشعري أي ثقل، فلا أستطيع العمل من دون نظام.
ألم تُغرك كتابة قصيدة نثر؟
بمَ يفيدني هذا الأمر؟ أستطيع في قصيدة أن أغيّر بعض المفردات، هل تصبح قصيدة نثر؟ هذا سؤال مطروح عليكم.
تبقى الغنائية الخارجية رغم ذلك.
لا، فهذه تزول مع زوال الوزن، فعندما يكفّ الإيقاع عن أن يكون معروفاً لا يعود مسموعاً، حين ترى أنّ هذا غير موزون تقول إنّه شعر نثر، هناك أيضاً ما يمكن أن نسمّيه بالنثر الموزون، شعر أبي العتاهية هو نثر موزون مثلاً، في أيّ حال اقتراحي أن نتوقف عن هذه السجالات، ما ينقصنا هو أن نجد حلولاً لهذه المشكلات، لا حلولاً نظرية.
هل تابعت السجال الدائر حالياً في مصر حول قصيدة النثر؟
لم أتابعه، وكما قلت ينبغي أن تتوقف هذه السجالات، أنا أستمتع بالكثير من تجارب شعراء النثر أكثر ممّا أستمتع بتجارب الشعر الموزون، وأظن أنّه حتى قصيدة النثر ينبغي أن تتحرر من تحديدات الاسم، أي نفي صفة الشعر عنها، والقول بالقصيدة، لماذا القول قصيدة النثر؟
جدّي كان الأقرب إليّ، وأعتبره أبي الروحي والعاطفي، كان يدللني صغيراً، ويصطحبني معه أينما يذهب
فالقصيدة هي تحقق الشعرية في الشكل، لنسمّ قصيدة النثر شعراً فحسب، ولديّ ملاحظة هنا، أيضاً إنّ قصيدة النثر تغري بالسهولة، إذ ينتج الكثير من التجارب التي هي أقرب إلى الخواطر، من دون البحث الشعري أو تصور ما عن الشعر، وهذه التجارب بحاجة للدفاع عن نفسها إبداعياً.
كتبت المقالة بكثرة، لكنّك شعراً لم تجنح إلى التنظير، هل كان هذا خيارك؟
كان خياراً واعياً منذ البداية، أخاف أن أسجن نصّي الشعري في نظريته، أخاف أن تصبح النظرية سابقة على النص، إذا كنت منظّراً مهما كنت منفتحاً على سائر الخيارات، فأنت منحاز إلى خيارات النظري، وإذا ملت إلى تجارب أخرى، تكون كمن يدمّر نظريته. وهذا لا ينفي أنّ هناك شعراء كباراً اشتغلوا في التنظير، ومنهم الإيطالي العظيم مونتاليو وأودن وأوكتافيو باث الذي أشعر أنّ تنظيره أهم من شعره، وبالتالي لست ضد التنظير، لكنّه ليس خيارياً.
تجربة ونهج
متى شعرت خلال تجربتك الإبداعية أنّك في ورطة، وأنّك وصلت إلى حائط مسدود بسبب تصورات أو متطلبات شعرية معينة؟
حين تمرّ في هذه الورطة من الأفضل ألّا تكتب، أنا أعيش في هذه الورطة منذ البداية، بل إنّني أقفز من ورطة إلى أخرى، وأنا كثير الإحباطات، وليس لدي ضمانات نهائية فيما يتعلق بشعري.
هذه الورطات تولد شعراً أحياناً، ورطات جدلية.
نستطيع أن ننظر هنا لنقول إنّ الكلام على أزمة في الشعر لا معنى له، لأنّ الشعر في أزمة دائمة، ووعي الشاعر بأزمته يساعده على تجاوزها، الأزمة ملازمة لكل عمل إبداعي، أزمة الأفق غير المضمون.
هل تتخلص من قصائد لا ترضى عنها؟
كثيراً، مثلاً "لماذا تركت الحصان وحيداً" كان نحو (60) قصيدة، وتخلصت من نصفه تقريباً، فأنا محرر صارم لشعري. الكتابة الأهم عندي هي الثانية، الكتابة الأولى هي الكتابة الحرة، والكتابة الثانية هي الأمتع التي أهتم فيها في بناء النص وفي الإمساك أكثر بإيقاعه، والكتابة الثالثة هي التنقيح النهائي، وهذه أقوم بها بعد عرض عملي على عدد من الأشخاص، وخاصة على أشخاص لا علاقة لهم بالشعر، أي عينات قرّاء عاديين.
ماذا تطلب من هذا القارئ العادي؟ رأياً نقدياً؟
لا، أسأله بعد أن أريه النص هل ذكّرك هذا النص بي؟ هل هناك ما قرأته في هذا النص عندي من قبل؟ مثلا "الجدارية" أقرأتها لأحد الأصدقاء الذي لا علاقة له بالشعر، فقال لي: إنّه يشعر أنّه قرأ سابقاً الصفحات الـ3 الأولى، فحذفتها من دون تردد، لأنّني بتّ أشعر مثله أنّ هذه الصفحات مكررة.
ماذا تفعل حين تمتنع عليك الكتابة؟
أتوقف تماماً، مرّة في بيروت بقيت نحو (4) أعوام بلا كتابة، الشعر كالجنس لا يعاند، مكابدته وقسريته تضرّان به.
هل تشعر أنّك حين تريد كتابة نص جديد، في حال امتناع الكتابة، تلجأ إلى مشاعر النص السابق؟
لا، حين أريد كتابة نص جديد ينبغي أن أكون ابتعدت تماماً عن النص السابق، أحتاج إلى المسافة الزمنية والخروج تماماً، بل التمرد تماماً على المشروع السابق، أحتاج أن أنظف نفسي من تاريخي، أقرأ كثيراً في هذه الفترة، وأطلع على الكثير من المراجع، وهذا ما فعلته مثلاً قبل وخلال كتابة "أحد عشر كوكباً"، القراءات التاريخية تقرّبك من المكان وزمنه، تشعرك أنّك ملتصق به.
هل زرت غرناطة مثلاً بعد كتابتك عنها؟
زرتها بعد عامين تقريباً من كتابة النص، وجدت المكان نفسه كما تخيلته، الشيء الوحيد الذي لم يعد موجوداً كان الرياحين، أمّا عدا ذلك، فكان لديّ الشعور بأنّني أزور المكان للمرة الثانية.
هل تصيبك حالات انفعالية حين تتوقف عن الكتابة؟ هل تصطدم بالآخرين مثلاً؟
لا، يبقى انفعالي داخلياً، ونصيحتي في حالة كهذه ألّا يقرأ الشاعر شعراً، وأنصح الشعراء الشباب خاصة بقراءة كل شيء من الجغرافيا إلى التاريخ إلى السياسة إلى جيولوجيا البحار، أكثر ممّا يقرؤون شعراً، لأنّ جمال الشعر في ندرته، وليس في متناول اليد.
لا تنصح إذن بأن يقرأك الشعراء الشباب كثيراً؟
كل شغلي لن يؤدي إلى إشباع أحد.
هل تشعر أنّ النقد أفاد تجربتك الشعرية؟ هل كان هناك نقد حقيقي لشعرك؟
أتطلع إلى أن أستفيد من النقد، ولكن أغلب نقادي هم إمّا مداحون، وإمّا هجاؤون، وإمّا قراء سيرة شخصية، وإمّا قرّاء ومؤولون لسيرة المعنى أكثر ممّا هم قرّاء لمكونات النص الشعري، وإن كنت أعلق أملاً كبيراً على صبحي حديدي وغيره من الشعراء.
أتقرأ الرواية؟
كنت في السابق، لكن لم يعد لديّ الكثير من الوقت، تحتاج إلى وقت لتستمتع بشرط الرواية، أي المتعة.
هل هناك روائي تعتبره من روافدك الشعرية؟
لا.
هل تشاهد المسرح أو تقرأه؟
أحياناً، لكن لديّ شعور بأنّ المسرح انتهى.
في العالم، نعرف أنّ هناك حركة تتجدد في أماكن كثيرة من العالم.
لكن ليس في العالم العربي.
أصدرت الكثير من المجموعات خلال حياتك، هل أنت نادم على نشر إحداها؟ هل تتمنى أن يكون بعضها خارج تاريخك؟
لو افترضنا أنّ شيئاً من شعري لم ينشر، وأردت نشره الآن، لنشرت المجموعات الـ4 الأخيرة ربما، وحتى هذه المجموعات لكنت نشرت مختارات منها وليس كلها.
محطات في حياة درويش الشعرية
هل تستطيع تحديد محطات تطورك الشعري؟
المحطة الأولى كانت حين كتبت "العصافير تموت في الجليل" الذي اعتبرته قطيعة بالنسبة إلى عملي السابق. المحطة الثانية هنا في بيروت مع "انتحار العاشق"، لكنّ هذه المحطة أجهضت، بسبب الحرب والأجواء النفسية الضاغطة. محطة أخرى ربما كانت في "ورد أقل"، وبعدها جاء اشتغالي على التاريخ ابتداء بـ "أرى ما أريد"، و"أحد عشر كوكباً"، ثم جاءت السيرة الذاتية في "سرير الغريبة"، و"لماذا تركت الحصان وحيداً"، و"الجدارية".
هل ستتابع في السيرة الذاتية؟
أفكر في المتابعة لجهة أنّه لا عودة إلى الحيوات السابقة، أزمة الشخص تتغير، ولا عودة إلى ما كانه هذا الشخص، أستطيع القول إنّ الشعر الصافي، أي البحث عن الشعر الصافي، البلوري، بدأ هذا السعي من "أرى ما أريد".
هل كانت بيروت مؤثرة في تجربتك؟
عشت ببيروت في الحرب، لذلك لا أستطيع القول إنّها كانت مؤثرة، بمعنى أنّني لم أستطع القيام بمشروع متواصل هنا في بيروت.
قلت لي في حلقة سابقة إنّك بدأت فتى في محاكاة المعلقات، هل ما زال طموحك كتابة معلقة؟
كتبتها بالفعل في "الجدارية"، فالمعلقة هي ما يُعلّق على جدار، هذه القصيدة كتبتها مفترضاً أنّني لن أكتب بعدها، أي أنّ هذه شهادتي الشعرية وأثري الشعري.
أين أنت متجه شعرياً، إلى جدارية أخرى؟
أتجه إلى شيء أبسط، وهذا أفضل لي، لأنّني لا أستطيع مواصلة الصعود، فأنا لست متسلق جبال دائماً، يستطيع المرء أن يتسلق جبلاً عالياً، ثم يذهب في نزهة إلى أحد الحقول أو الحدائق، جميلة الحدائق.
ألن تتوقف عن الكتابة؟
حين أشعر أنّني غير قادر على الكتابة أتوقف تماماً، أو أتوجه نحو النثر، ولديّ بالفعل حنين إلى النثر، وأتمنى أن أفشل شعرياً لأتجه إلى النثر، لأنّني أحبه وأنحاز إليه، وأعتبر أنّ فيه أحياناً شعرية متحققة أكثر من الشعر نفسه.
*حوار قديم أجراه مع الراحل محمود درويش الشاعر سامر أبوهواش منشور في مجلة "نزوى" العُمانية









![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_3.png.webp?itok=m7qfTDwy)
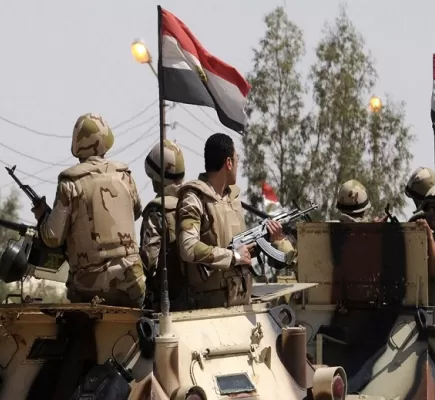
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_3.jpg.webp?itok=yQ6BBSL3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_6_1.jpg.webp?itok=nDkExL6a)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.jpg.webp?itok=L46ObaGI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86_1.jpg.webp?itok=_wTQr1NV)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/lzndny_56_0.jpg.webp?itok=LLzNBHuV)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_0_1_3_1.jpg.webp?itok=cVr6G9-Z)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_5.jpg.webp?itok=-5s4yUMM)






![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/344281-293240_0_0_0_0.jpg.webp?itok=WWTSS0RY)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A4%D8%B42.JPG.webp?itok=-j7U4JLd)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_3_2_0.jpg.webp?itok=vLdl7q_B)






![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)

